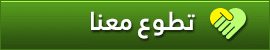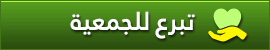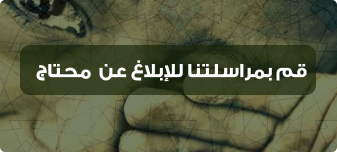التصنيف: مواضيع خيرية
فضائل الصدقة
للصدقة شأن عظيم في الإسلام، فهي من أوضح الدلالات، وأصدق العلامات على صدق إيمان المتصدق؛ وذلك لما جبلت عليه النفوس من حب المال والسعي إلى كنزه، فمن أنفق ماله وخالف ما جُبِل عليه، كان ذلك برهان إيمانه وصحة يقينه، وفي ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: (والصدقة برهان) أي: برهان على صحة إيمان العبد، هذا إذا نوى بها وجه الله، ولم يقصد بها رياء ولا سمعة.
لأجل هذا جاءت النصوص الكثيرة التي تبين فضائل الصدقة والإنفاق في سبيل الله، وتحث المسلم على البذل والعطاء ابتغاء الأجر من الله عز وجل.
فقد جعل الله الإنفاق على السائل والمحروم من أخص صفات عباد الله المحسنين، فقال عنهم: {إنهم كانوا قبل ذلك محسنين * كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون * وبالأسحار هم يستغفرون * وفي أموالهم حق للسائل والمحروم} (الذاريات:16-19)، ووعد سبحانه -وهو الجواد الكريم الذي لا يخلف الميعاد- بالإخلاف على من أنفق في سبيله، فقال سبحانه: {وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين} (سبأ:39)، ووعد بمضاعفة العطية للمنفقين بأعظم مما أنفقوا أضعافاً كثيرة، فقال سبحانه: {من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة} (البقرة:245).
والصدقة بالأموال من أنواع الجهاد المتعددة، بل إن الجهاد بالمال ورد مقدماً على الجهاد بالنفس في جميع الآيات التي ورد فيها ذكر الجهاد إلا في موضع واحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) رواه أبو داود.
وفي السنة من الأحاديث المرغبة في الصدقة، والمبينة لثوابها وأجرها، ما تقر به أعين المؤمنين، وتهنأ به نفوس المتصدقين، ومن ذلك أنها من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (وإن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كرباً، أو تقضي عنه ديناً، أو تطرد عنه جوعاً)، رواه البيهقي، وحسنه الألباني.
والصدقة ترفع صاحبها، حتى توصله أعلى المنازل، قال صلى الله عليه وسلم: (إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالاً وعلماً فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويعلم لله فيه حقاً فهذا بأفضل المنازل) رواه الترمذي.
وهي تدفع عن صاحبها المصائب والبلايا، وتنجيه من الكروب والشدائد، قال صلى الله عليه وسلم: (صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة) رواه الحاكم وصححه الألباني.
وجاء في السنة عظم أجر الصدقة، ومضاعفة ثوابها، قال صلى الله عليه وسلم: (ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب- إلا أخذها الرحمن بيمينه، وإن كان تمرة، فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فُلُوَّه أو فصيله) رواه مسلم.
والصدقة تطفئ الخطايا، وتكفر الذنوب والسيئات، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: (والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار) رواه الترمذي.
وهي من أعظم أسباب بركة المال، وزيادة الرزق، وإخلاف الله على صاحبها بما هو أحسن، قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: (يا ابن آدم! أَنفقْ أُنفقْ عليك) رواه مسلم.
كما أنها وقاية من عذاب الله، قال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا النار ولو بشق تمرة) رواه البخاري.
وهي دليل على صدق الإيمان، وقوة اليقين، وحسن الظن برب العالمين، إلى غير ذلك من الفضائل الكثيرة، التي تجعل المؤمن يتطلع إلى الأجر والثواب من الله، ويستعلي على نزع الشيطان الذي يخوفه الفقر، ويزين له الشح والبخل، وصدق الله إذ يقول: {الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً والله واسع عليم} (البقرة:268)، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المنفقين في سبيله وألا يجعلنا من الأشحاء والبخلاء في طاعته، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير.
زكاة الفطر حكمها وقدراها ووقت اخراجها
سوف نتكلَّم عن زكاة الفطر، من حيثُ:
أولاً: حكمها والحكمة منها.
ثانياً: جنسها.
ثالثاً: قدرها.
رابعاً: وقت إخراجها.
خامساً: مكان إخراجها.
أما الأول: من حيث حكم الصدقة:
فحكمها أنها فريضة فرضها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما في حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاةَ الفطر، صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير».
وقال أبو سعيد رضي الله عنه: «كنا نُخرجها على عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام، وكان طعامنا التمر، والشعير، والزبيب والأقط»، ولم يكن البر شائعاً في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وإنما كثر البر وشاع بعد ذلك.
فهذا حكم هذه الزكاة، فهي فريضةٌ على الصَّغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، وأما الحمل في البطن فإنَّ الإخراج عنه ليس بواجب، وإن أخرج الإنسان عنه تطوعاً فقد روي ذلك عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه.
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» دليل على أنها فرض عين.
والأصل في فرض العين أن يكون على المكلف نفسه، أي على من فُرض عليه.
فالإنسان يجبُ أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسه، والابن يجب أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه، وكذلك كلُّ مُكلَّفٍ يجب أن يُخرج زكاة الفطر عن نفسه؛ لأنه هو المخاطب بها، ولكن إذا كان ربُّ الأسرة يُخرج زكاة الفطر على مشهدٍ من أهله وأولاده، فإذا وافقوا على أن يكون هو المُخرجُ للزكاة فلا حرج في هذا.
وأمَّا الحكمة من فرض هذه الزكاة، فالحكمةُ جاء بها الحديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر، طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمة للمساكين».
هذه هي الحكمةُ، فهي طُهرة للصائم، لأنَّ الصائم لا يخلو في صومه من لغوٍ، ورفث، وكلامٍ محرم، فهذه الزَّكاة تطهر الصوم، وكذلك تكون طعمة للمساكين في هذا اليوم، أي يوم العيد، لأجل أن يُشاركوا الأغنياءَ فرحتهم بعيدهم.
ثانياً: وأما جنسُ هذه الفطرة:
فاستمع إليها من الحديث الذي أشرنا إليه: «فرضها صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير»، وقال أبو سعيد: «كنا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً من طعام»، فالذي حدَّث «أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من شعير» هو عبد الله بن عمر، والذي قال: «كُنَّا نخرجها صاعاً من طعام» هو أبو سعيد الخدري، وكلاهما من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رضي الله عنهما.
فابنُ عمر رضي الله عنهما، حكى فرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بجنس هذه الزكاة، من كلام الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فرضها صاعاً من تمر أو من شعير».
وأبو سعيد رضي الله عنه ذكر حال النَّاس في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأنهم «يُخرجونها صاعاً من طعام»، وبهذا يتبيَّنُ أن الجنس الواجب إخراجُه في زكاة الفطر هو الطعام، وأنَّ الإنسان لو أخرجها من الدراهم فإنها لا تُجزئه، ولو أخرجها من الثِّياب فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الفرش فإنها لا تجزئه، ولو أخرجها من الآلات الأخرى كالأواني ونحوها فإنها لا تجزئه، لأنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من تمر، أو من شعير.
وكلُّ قياس أو نظر، يُخالف النصَّ فإنَّه مردود على صاحبه، ونحن مُتعبَّدون لله عز وجل بما جاء في شريعة نبينا محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لسنا متعبدين بما تهواه نفوسنا، أو بما تُرجِّحه عقولنا، مادام في المسألة نصٌّ، فإنه لا خيار لنا فيما نذهب إليه ولا اختيار: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً}.
فإذا كان هذا ابنُ عمر رضي الله عنهما يقول: «فرضها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعاً من تمرٍ أو صَاعاً من شعير».
وإذا كان أبو سعيد الخدريِّ رضي الله عنه، يقول: «كُنَّا نُخرجها صاعاً من طعام»، فهل الدراهم في عهد الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مفقودة حتى لا تجد إلا الطعام؟
كلا، بل الدراهم كانت موجودة، والذهب موجود، والفضة موجودة، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فيما صح عنه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبر، والتمر بالتمر، والشَّعير بالشَّعير، والملح بالملح».
كلُّ هذا موجود في عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولم يختر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يفرض زكاةَ الفطر على أمَّته إلا صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، فكيف يسوغُ لنا بعد ذلك أن نقول: إنَّ الأفضل الآن أن نخرجها دراهم؟! إنَّ هذا القياس في مقابلة النص، وهو مردود وفاسد الاعتبار.
نعم قد نقول: إنَّ الأنفع أن نُخرجها من الدَّراهم؛ لأنَّه إذا أخرجناها من الدَّراهم انتُفِعَ بها، ولكن مادام الأمر منصوصاً عليه، فإنَّه لا عدول لنا عمَا نص عليه الشرع، فالشرع أعلم منا، فقد يكون في هذا الزمن الدراهمُ خيرٌ من الطعام، لكن ربما تأتي أزمانٌ يكون الطعامُ خيراً من الدراهم، بل قد يكون الصَّاعُ من الطعام يُعادل صاعاً من فضة.
والناس إذا قلنا لهم: أخرِجوها من الدراهم واعتادوا إخراجها من الدراهم صعُب عليهم الانتقال فيما بعد إلى إخراجها من الطعام؛ ذلك لأنَّ إخراجها من الدراهم أسهل وأيسر، ولأنَّه إذا غلا الطعام وارتفعت أسعاره، فإن الإنسان يصعب عليه أن يُخرج الطعامَ لكونه غالياً، ولكون سعره رفيعاً.
فلهذا كانت الحكمةُ -بلا شكٍّ- هي ما قال به رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
ويقول بعض الناس: إننا إذا أعطينا الفقير صاعاً من طعام، فإنه يبيعه ونحن نراه رأيَ العين ويبيعُه بنصف ثمنه، أو أقلَّ أو أكثر؟
فنقول: نحن ليس علينا من فعل الفقير شيءٌ، بل علينا أن نفعل ما أُمِرنا به، وأن نقول: سمعنا وأطعنا، وأن نبذُل الطعام، ثم للفقير الذي ملكه الخيارُ فيما شاء، فإن شاء أكله، وإن شاء ادَّخره، وإن شاء باعه، وإن شاء أهداه، وإن شاء دفعه صدقة عن نفسه، فليس علينا من هذا شيء، فالشيء الذي أمرنا به صاعاً من طعام.
وما موقفنا أمام الله عز وجل، إذا خالفنا ما فرضه رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فهل لنا حُجَّة أن نقول: يا ربّنا إنَّنا رأينا أنَّ الدراهم خير، أبداً.
فإنَّ الخير ما اختاره الله لنا، وما اختاره رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لنا.
فيا عبادَ الله،
لا نذهب بعيداً في القياس، حتى نتجاوزَ ما فرضه الله علينا، فإنّ عقولنا متهمة، وإن عقولنا قاصرة، وإنَّ الشرع محكم من عند الله عزّ وجلّ، لا يُمكن أن يكون فيه خلل، ولا نقص، وإن عقولنا لا تتجاوز نظر ما نحن فيه في هذا العصر. ولكنَّ علم الله عز وجل المحيط بكل شيء، والذي فرض علينا أن نخرج هذه الصدقة صاعاً من طعام، إنه علم لا نهاية له. فإني أقول ذلك نصحاً لكم، وإقامة للحجة، وإبراءً للذمة، وحتى لا يغترَّ مغترٌّ بما يراه بعضُ الفقهاء؛ لأنّ كلَّ إنسان يؤخذ من قوله ويُترك إلا رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وإذا كان رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعاً من تمر، أو شعير، وهو طعام ذلك الوقت، فإنَّنا سنرفض قول كل مَن سواه، لقول رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وهل يجب أن يكون هذا الطعام، من أشياء معيَّنة وهي البُرُّ، والتمر، والشعير، والزبيب، والأقط، أو يجزئ من أيِّ طعام؟
الجواب: إذا نظرنا إلى حديث أبي سعيد الخدري: «كنَّا نُخرجها صاعاً من طعام، وكان طعامُنا التمرَ والشَّعير والزَّبيب والأقط».
وإذا نظرنا إلى حديث ابن عبَّاس، فرضها رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «طُهرةً للصائم من اللَّغو والرَّفث، وطُعمةً للمساكين»، علمنا أنَّ الطعام هو الواجبُ، سواء كان من هذه الأصناف الخمسة أم من غيرها، وأنَّ هذه الأصناف الخمسة إنما ذُكِرَت لأنَّها كانت طعامَ الناس في ذلك الوقت، ويكون التَّنصيصُ على أعيانها من باب التَّمثيل، لا من باب التَّعيين.
وعليه فإذا وُجِدَت أطعمةٌ أخرى للنَّاس يطعمونها، فإنَّنا نُخرج من هذه الأطعمة، فيُوجد الآن أطعمةٌ أنفع للناس من هذه الأطعمة، مثل الأرز، فإنَّ الأرز الآن طعامُ غالب الناس في هذه البلاد، وهو أنفعُ بكثير للناس من بقيَّة هذه الأنواع، فإذا أخرج الإنسان من الأرز فإن ذلك مجزئٌ، بل قد نقول: إنَّه الأفضل، لأنَّه أنفعُ للفقير وأيسر، ولقد قدَّرنا أنَّنا في منطقة لا يطعم أهلُها إلا السمك هذا طعامهم، فهل يجزئ من السمك، نعم يجزئ؛ لأنَّ العِبرة بما كان طعاماً، وهو يختلفُ باختلاف الأزمان، واختلاف الأحوال واختلاف البلدان.
وعليه فالمدارُ على الطعام، وهذا جنسُ ما تُخرج منه الفطرة.
ثالثاً: أمَّا قدره:
فإنه صَاعٌ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «فرضَ رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر صاعاً»، وقول أبي سعيد رضي الله عنه: «كُنَّا نُخرجها صاعاً من طعام».
ومن المعلوم أنَّ هذه الأصناف التي جاءت في الحديث، عن أبي سعيدٍ أربعة: تمر، وزبيبٌ، وشعير، وأقط.
والأقط هو اللبن المجفف يُجعل أقراصاً، أو يُجعل فتيتاً ويؤكل، فهذه الأصناف: هل هي متَّفقة القيمة أو مختلفة؟
الغالب أنها مختلفة، لكن ربما يأتي زمان تتَّفق، ولكن الغالب أنها مختلفة.
ولماذا قدَّرها الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعاً مع اختلافها؛ لأجل أن لا يكون هناك افتراق؛ لأنه لو قيل الواجب صاعاً من تمر، أو ما يعادله من الزبيب، أو الشعير، أو الأقط حصل اختلاف في التقويم، وصار هناك ارتباك.
ولكن الشَّرع جعلها صاعاً؛ لأجل أن يكون أضبطَ للناس، ويُخرج الإنسان من هذه الأنواع ومن غيرها ما يكون طعاماً، فإذا قلتَ ما مقدارُ الصَّاع؟
فإنَّنا قد حرَّرناه، فبلغ كيلوين وأربعين غراماً بالبرّ الرَّزين الدجن الذي ليس خفيفاً وليس فيه عيبٌ.
فإذا اتَّخذت إناءً يسع كيلوين وأربعين غراماً من البُرِّ الرَّزين، ثمَّ قست به الفطرةَ فقد أديت الصّاع، ومعلومٌ أنَّ هذا المقدارَ أقلُّ من الصَّاع المعروف الآن، وأقلُّ من الكيل المعروف في الحجاز.
لكنَّ صاع النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أقلُّ من الصاع المعمول بنجد، ومن الكيل المعهود في الحجاز.
رابعاً: وقت الإخراج:
زمانُها يوم العيد قبل الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وأمَرَ أن تؤدَّى قبل خروج النّاس إلى الصَّلاة»، هذا زمانها، وهذا أفضلُ وقت تُخرج فيه.
ولكن يجوز أن تُخرج قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوزُ أن يُخرجها ليلة التاسع والعشرين، ويجوز أن يُخرجَها يوم التاسع والعشرين، يجوز أن يُخرجها ليلة الثَّلاثين ويوم الثَّلاثين.
أمّا إخراجها يوم سبعٍ وعشرين، فإنَّه لا يجزئ، وأمَّا إخراجها في اليوم الثَّامن والعشرين فعلى خطر، فإن كان الشهرُ ثلاثين لم تجزئ، وإن كان الشهر تسعة وعشرين أجزأ، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يُخرِجها قبل اليوم التاسع والعشرين، لئلا يقع في الخطر.
وأمَّا إخراجها بعد صلاة العيد، فإنه محرم، ولا يجوز، ولا تُقبل منه على أنها صدقة الفطر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «من أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مقبولة، ومن أدَّاها بعد الصَّلاة، فهي صدقةٌ من الصَّدقات»، اللهم إلا إذا أتى العيدُ والإنسان ليس عنده ما يُخرج، أو ليس عنده من يُخرجُ إليه، ففي هذه الحال يُخرجها متى تيسَّر له إخراجها.
وكذلك لو لم يعلم بالعيد، إلا في وقتٍ مباغتٍ لا يتمكَّن من إخراجها قبل الصلاة وأخَّر إخراجها، فإنَّ في هذه الحال تُخرج ولو بعد الصلاة، وكذلك لو اعتمد بعض الناس على بعض، مثل أن تكون العائلةُ اعتمدت على قَيِّمِهم وهو في بلد آخر، ثم تبيَّن أنه لم يُخرج، فإنه يُخرج ولو بعد العيد، وكذلك لو كان أحدٌ من الناس في بلدٍ آخر كبلاد الغرب مثلاً، وقد اعتمد في الإخراجِ على أهله، وهم اعتمدوا في الإخراج عليه، فإنَّه في هذه الحال تُخرج ولو بعد العيد.
خامساً: وأما مكان إخراجها:
فإنّ مكان إخراجها، هو المكانُ الذي يدركك العيد وأنت فيه، سواء كان بلدك أم بلداً آخر.
وعلى هذا فالمعتمرون في مكة الَّذين سيبقَون إلى العيد، الأصل أنهم يُخرجون زكاة الفطر في مكة، فيكونُ قد اجتمع في حقهم: أنّ مكة مكان إقامتهم في وقت الإخراج، وأنَّ مكة أفضلُ من غيرها؛ لأنَّ الأعمال الصَّالحة في مكَّة، أفضلُ من الأعمال الصَّالحة في غيرها.
وإذا كنتَ في بلدٍ آخرَ غيرِ مكّة وأدركك العيد، فإنك تُخرج الزكاة في البلد الذي أدركك العيدُ وأنت فيه.
وهل يجوز أن تُخرجها في محلّ إقامتك، بأن تُوكِّلَ أهلك في إخراجها؟
نعم يجوز ذلك ولا حرج.
والله أعلم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فضل كفالة اليتيم في الدنيا والآخرة
من الكتاب والسنة في حق اليتيم
وقال رب العزة سبحانه وتعالى:﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لاعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ صدق الله العظيم.
قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز :وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ صدق الله العظيم.
ال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا قَلِيلًا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: كَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ ، أَوْ لِغَيْرِهِ ، أَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ ، إِذَا اتَّقَى اللهَ. وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى. أخرجه أحمد ومسلم
كيفية تقدير كفالة اليتيم المادية :
يتم تقدير الكفالة المالية لليتيم على حسب معيشة الطفل وظروف البلد التي يعيش فيها بحيث يتوفر لليتيم طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه وتعليم مناسب ليحيا حياة كريمة ، وقد ذكر في الأثر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الايتام ليعيشوا مع أبنائهم بدون أي تفرقة في المعاملة بينهم.
تحديد وقت الكفالة لليتيم :
كفالة اليتيم ترتبط بموت والده ولكن عند بلوغه سن الرشد فيصبح رجلا ويستطيع أن يعول نفسه إلا إن كان يعاني من الجنون أو اصابة عقلية فيظل في حكم الكفالة، أما الفتاة فتظل في الكفالة أن يأتي وقت نكاحها وتصبح على كفالة زوجها .
أمثلة الأيتام في الاسلام
وقد كان من أفضل الامثلة التي جعلها رب العالمين لتكريم اليتيم هو نبيه ورسوله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد ولد يتيما وضرب مثلا في الخلق والاخلاق التي أصبح بها قدوة لجميع المسلمين وبها أجبر المشركين على احترامه، وبهذا المثل يرفع الله قدر اليتيم وقد أوصى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم باليتيم وكفالته حينما أكد أنه وكافل اليتيم إلى جوار بعضهما في الجنة.
نماذج كثيرة لأيتام في التاريخ الاسلامي:
اذا بحثنا عن الشخصيات العظيمة التي عانت اليتم وألمه لنجدها كثيرة للغاية وفي مقدمتهم سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد ولد يتيما ، وتربي يتيما ، وهناك أيضا من الأيتام المشهورين في التاريخ الاسلامي
الامام الشافعي : ويعد الامام الشافعي رضي الله عنه من أشهر اليتامى فقد تربى يتيما واجتهدت والدته في تربيته رغم ضيق العيش وقلة المال وعلى الرغم من تلك الظروف فقد اجتهد في العلم حتى صار مرجعا هام وأقام أحد المذاهب الاربعة.
الامام أحمد بن حنبل : لدينا الامام أحمد ابن حنبل وقد توفى والده وأمه حاملا فيه وقد عانى من الفقر والمعيشة والرزق القليل واجتهدت والدته في تربيته وكانت تسانده في تحصيل العلم حتى أصبح عالما كبيرا وتتلمذ على يديه الكثيرين من طلبة العلم.
الامام البخاري : وكذلك الامام البخاري فكانهو الأخر من اليتامى وتربى يتيما ايضا حتى أصبح من أشهر علماء الحديث.
فضل كفالة اليتيم في الدنيا والاخرة :
1- الصحبة والجوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة .
2- صدقة تعطي كضعف في الرزق والمال.
3- تحسين الخلق بعد كفالة اليتيم.
4- ترقيق القلب والاحساس والمشاعر عند مسح راس اليتيم.
5- زيادة الخير والرزق مع الاهتمام بكفالة اليتيم.
6- كفالة اليتيم تقرب إلى الله وتقرب العبد بأخلاق الرسول وجعله قدوة.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ( أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يشكو قسوة قلبه ؟ قال: أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ ارحم اليتيم وامسح رأسه وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك ) رواه الطبراني